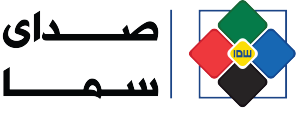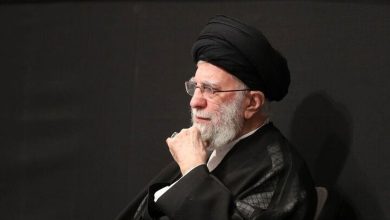كيف يمكن للعربي تجاوز سقطاته وهزائمه؟

 مجاهد الصريمي صنعاء:
مجاهد الصريمي صنعاء:
عمل الظالمون والمستكبرون عبر التأريخ على تعميم ثقافة الانهزامية والضعف في الذهنية العامة لجماهير الأمة، حتى ساد في وعي حملة الحق تصوّرٌ مغلوط، مفاده أن الحق لا يمكن أن ينتصر، وأنه من المستحيل أن يأتي اليوم الذي نرى فيه الحق وقد عمّ نوره الوجود، وشمل بتعاليمه وأحكامه وثقافته وبركاته الساحة الكونية برمّتها، وبات يسوغ الواقع بناءً على ما يختزنه من قيم ومبادئ، ويصنعه على صورته شكلاً ومضموناً.
فبدأت هذه الثقافة العارية عن الصحة تخرج إلى العيان، عن طريق الكمّ الهائل من الكتب والشروحات والمؤلفات، التي سعت – من خلال ما اشتملت عليه من قضايا وأفكار – إلى جعل ما يعيشه أهل الحق من ذلّة وهوان وغربة واضطهاد وظلم وتنكيل، ما هو إلا سُنّة من السنن الإلهية التي جُبِلت عليها الحياة الإنسانية، شأنها شأن بقية السنن والقوانين والنظم الحاكمة لحركة الكون، تماماً كما هو الحال في مسألة تعاقب الليل والنهار، التي لا سبيل إلى تغييرها أو التمرّد عليها.
وقد كان الدافع وراء مثل هذه الكتب والأحاديث هو الخوف من الدخول في مواجهة
مع الاستكبار والاستبداد والانحراف والظلم، وهو البرنامج الذي تسير عليه جميع قوى الباطل في كل عصر ومصر، إلى جانب سيطرة تلك القوى على مجمل الدوائر الفكرية والثقافية، مع بثّ الكثير من الأخبار لدى الرأي العام التي تحكي معاجز وكرامات وقدرات الحاكم أو الأمير أو الوالي الخارقة. ومنها – على سبيل المثال – تلك الترهات التي كان يبثها الجهاز الحاكم في زمن المنصور العباسي، والتي ورد في إحداها أنّه كان يمتلك مرآةً يستطيع من خلالها رؤية مخابئ معارضيه والمناهضين لحكمه.
وقد يُقدَّم الظالمون للناس على أنّهم أهل زهد وتقوى وورع؛ كأن يُقال عن فلان: كان يقرأ القرآن في ركعة، أو كان يصلّي ألف ركعة في الليلة الواحدة، أو كان يقرأ القرآن ويبكي حتى تتصاعد من فيه رائحة الشواء نتيجة احتراق كبده وتلظّي أحشائه خوفاً من الله أو اشتياقاً لرسوله الكريم، أو لوعةً على فراقه. أو يُقال: إن فلاناً كان يحج عاماً ويغزو عاماً.
وهكذا يصبح الإذعان لظلم أولئك والخضوع لجورهم وتسلّطهم ديناً يتقرّب العامة من الناس إلى الله به، إذ كيف لهم أن يعترضوا على مَن يقيم ليله بالصلاة وتلاوة القرآن كله؟! وأنّى لهم أن يرفضوا حاكماً مُبشَّراً بالجنة؟! أو حتى أن يفكروا – مجرد تفكير – في الانقلاب على من يوزّع سني عمره مناصفةً بين حج البيت والجهاد في سبيل الله؟
وهكذا تجد غالبية المدارس الإسلامية تساوي بين الحق والباطل، وتجعل المحقّ والمبطل في درجة سواء من المنزلة والفضل، هذا إن لم يدفعها تعصّبها لأهل الباطل إلى النيل من أهل الحق وتجريم تحركاتهم ونشاطاتهم في مواجهة ما كان عليه الواقع من بغي وفساد.
ونتيجةً لهذا كله يتصاعد النفور في أوساط المجتمع من الدين والتديّن، ويصبح مَن ينادي بالاعتماد على الله، والثقة به سبحانه، والتوكّل عليه، والعمل على إقامة الحياة بكل تفاصيلها وفق ما أراده وبيّنه في كتابه، محطاً للسخرية والتندّر. كما يصبح حملة الحق في وضعيّة المجبر على التنازل عن جميع قناعاته وأفكاره وعقائده، كي لا يُقال عنه: متخلّف ورجعي وأصولي وغير ذلك… ومن ثم يتوجّه إلى الانسلاخ عن جلده، والتنكر لأصوله وثوابته شيئاً فشيئاً، حتى يذوب في الآخرين ويصير مجرّد تابع لا هوية له ولا شخصية ولا إرادة ولا قرار.
وعليه، إذا أردنا تجاوز معظم سلبيات وسقطات الحاضر فعلينا تصويب النظرة من الأساس إلى الماضي، فكل انحراف أو فهم مغلوط أو ضلال أو جنوح إلى التماهي مع الباطل أو التعايش مع الظالمين اليوم، لا يمكن معالجته أو القضاء عليه إلا إذا عملنا على استئصال جذوره التي نمت في الماضي، وقدّمها لنا المؤرخون كمسلّمات لا يجوز تناولها بالدرس والمناقشة. فنتج عن ذلك أجيال تقدّس الخرافة والجهل وتحارب الحقيقة أينما كانت.
كم لدينا من أمثال ذلك؟
عام 1917م دخل الجنرال الإنكليزي ستانلي مود إحدى المناطق في دولة عربية، فصادفه راعي أغنام. فتوجّه إلى الراعي وطلب من المترجم أن يقول له: “الجنرال سيعطيك جنيهاً استرلينياً إذا ذبحت كلبك الذي يجري حول الأغنام”.
الكلب يمثّل حاجةً مهمّة للراعي لأنه يسير القطيع ويساعد في حمايته من المفترسات، ولكن الجنيه في ذلك الوقت كان يساوي نصف القطيع. سُرَّ الراعي، وجلب الكلب وذبحه تحت أقدام الجنرال.
حينها قال مود: “أعطيك جنيهاً إضافياً إذا سلخت جلده”. فبادر الراعي إلى سلخه. ثم قال له: “أعطيك جنيهاً ثالثاً إذا قطّعته إلى قطع صغيرة”. ففعل الراعي ذلك. فأعطاه الجنيه وانصرف.
ركض الراعي خلفه منادياً: “هل تعطيني جنيهاً آخر وآكله؟”
فأجابه الجنرال: “كلا، أنا رغبت فقط في معرفة طباعكم وفهم نفسياتكم؛ فأنت ذبحت وسلخت وقطّعت أغلى صديق عندك ورفيقك من أجل ثلاثة جنيهات، وكنت مستعداً لأكله مقابل جنيه رابع. وهذا ما أحتاجه هنا وما أودّ معرفته”.
ثم التفت بعدها إلى جنوده وقال: “ما دام هناك الكثير من هذه العقليات فلا تخشوا شيئاً…”
القصة يرويها الدكتور علي الوردي في كتابه لمحات اجتماعية من تاريخ العراق. وهي تظهر بعض النفسيات الضعيفة الموجودة في كثير من مجتمعاتنا، المستعدة لفعل أي شيء مقابل المال، دون إدراك أنها باعت الغالي بالرخيص. وهذا ما يستخدمه أي احتلال أو عدو لتفكيك المجتمعات على مرّ التأريخ.
فكم يوجد اليوم من بين شعوبنا من هو مستعد أن يأكل – ليس من لحم كلبه – بل من لحم أخيه، طلباً للمال؟!
إن أغلب معاييرنا اليوم تم تفريغها تدريجياً من محتواها الدلالي – وخاصة المعنوي – وتم إحلالها بدلالات مادية محضة، وبطريقة ناعمة تعمل في منطقة اللاوعي، ثم تتحوّل تدريجياً في المجال الإدراكي إلى وعي، بعد أن تمهّد القابلية الحسية والعقلية لقبول المعايير بحلّتها الجديدة. وهذه الحُلّة الجديدة لا تعني تغيير ظاهرها حتى لا تُواجَه بالرفض، بل تعني تغيير محتواها الداخلي والمعنوي بالذات مع الحفاظ على شكلها وظاهرها.
ولا يخفى على أحد أن هناك وسائط وأدوات ومصوّغات يتم بواسطتها إحداث عملية تفكيك منهجي وفكري من قبل الاستكبار لكل مجتمعاتنا، ومن تلك الوسائط والأدوات:
- سهولة الحصول على التكنولوجيا والإنترنت وانتشارهما بطريقة أوجدت صعوبة في الاستغناء عنهما، ليصبحا من الضروريات الحياتية حتى لفقراء الحال.
- وجود الأرضية والقابلية لعملية التفكيك نتيجة الوهن والضعف في جسد الأمة، وغياب المنهج والأدوات العقلية في تحقيق المعارف وتقييمها، لانعدام المشاريع النهضوية الثقافية.
- الاستبداد وتحالفاته التي جعلت كثيراً من الفقهاء أتباعاً للبلاط يشرعنون وجوده، واستقطبت كثيراً من المثقفين إلى البلاط نفسه من خلال إنشاء مراكز دراسات بدعم حكومي تشغل المثقفين بانشغالات فكرية وثقافية لكنها غالباً مخملية بعيدة عن هموم الناس والواقع؛ تنظيرية غير قابلة للتطبيق أو لجذب الناس. فخدّرت عدداً كبيراً من المثقفين بالثقافة، وشغلتهم عن الجماهير وعزلتهم، فهیمنت على الجمهور بالقوة وعطّلت العقول بالفتوى.
- تردّي مستوى التعليم في المجتمعات، مع انتشار المناهج الدينية المتطرفة التي عطّلت قدرة العقل على السؤال، من خلال ثقافة الإقصاء وحصر الحقيقة في منهج واحد لا شريك له.
- عجز الوسط المتديّن عن تقديم مشاريع نهضوية قادرة على تثبيت الثابت وتطوير المتغيّر، بل كان سبباً في تسرب عدد كبير من الشباب إلى أحضان الحداثة والعولمة، بعد عجزه عن الإجابة على التساؤلات العقدية الكبرى.
- تمييع الهوية من خلال تغيير قائمة الأولويات، وضرب منظومة المعايير والقيم، وتضارب الواقع مع النظريات، لابتعاد المنظرين عن واقع الناس وحاجاتهم وأهم إشكالياتهم التي تصوغ لهم كثيراً من التساؤلات وتضعهم في فوضى الأفكار.