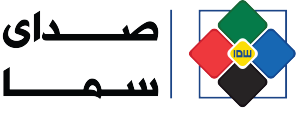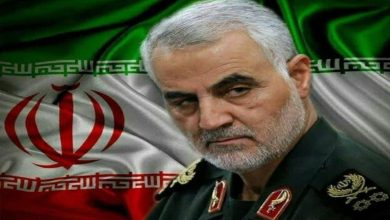كيف تحولت «حقوق الإنسان» إلى سلاح غربي؟

 القسم السياسي:
القسم السياسي:
الأول من أغسطس كان الذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقيات هلسنكي؛ ذكرى مرّت تقريباً من دون اهتمام يُذكر من وسائل الإعلام السائدة، غير أنّ آثارها لا تزال تُثقل كاهل أوروبا والعالم. فهذه الاتفاقيات لم تُوقّع فقط على شهادة وفاة الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو ويوغسلافيا بعد سنوات، بل أسست أيضاً لنظام عالمي جديد، نظامٍ أصبحت فيه «حقوق الإنسان» – لا سيما بصيغتها الغربية وتفسيرها المفروض غربياً – أداة سياسية وسلاحاً فعالاً في ترسانة الإمبراطورية الغربية.
الهدف المعلن لهذه الاتفاقيات كان تخفيف التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ووفقاً لنصوصها، اعترفت واشنطن بنفوذ موسكو السياسي في أوروبا الوسطى والشرقية، في مقابل التزام الاتحاد السوفييتي وحلفائه بتعريف ضيق لـ«حقوق الإنسان» يقتصر على الحريات السياسية مثل حرية التعبير، والتجمع، والمعلومات، والتنقل. أما الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي كان يتمتع بها سكان الكتلة الشرقية – كالتعليم المجاني، والعمل المضمون، والسكن والخدمات الاجتماعية – فقد جرى استبعادها تماماً من هذه الصياغة.
بالتوازي مع ذلك، تأسست مجموعة من المنظمات الغربية لمراقبة مدى التزام الكتلة الشرقية بالاتفاقيات، من بينها «هلسنكي ووتش» التي تحولت لاحقاً إلى منظمة «هيومن رايتس ووتش». هذه المنظمات كانت تزور دول الكتلة الشرقية باستمرار، وتبني علاقات مباشرة مع المعارضين السياسيين هناك، وتقدّم لهم الدعم في أنشطتهم المناهضة للحكومات.
وكما أوضح الباحث القانوني صموئيل موين، فقد غيّرت اتفاقيات هلسنكي جذرياً الخطاب الحقوقي، إذ جرى تقليص حقوق الإنسان من مجال يشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية إلى مجال سياسي بحت، وأصبحت أداة لـ«إحراج الحكومات». هذا التحول منح الغرب مبرراً أخلاقياً ظاهرياً لفرض العقوبات الاقتصادية، وتنظيم الانقلابات، وإشاعة عدم الاستقرار، وصولاً إلى التدخلات العسكرية المباشرة ضد الدول المصنّفة كمنتهكة لـ«حقوق الإنسان». وغالباً ما جاءت تقارير العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» كغطاء محايد لهذه السياسات الإمبريالية.
بعد توقيع الاتفاقيات، ظهرت داخل الكتلة الشرقية مجموعات تعنى بتوثيق ما يُسمى «انتهاكات حقوق الإنسان» من جانب السلطات. كانت تقارير هذه المجموعات تُنقل سرّاً إلى السفارات الغربية والمنظمات الحقوقية، ليجري تضخيمها على المستوى الدولي، وهو ما زاد الضغط على الاتحاد السوفييتي وحلفائه. السردية الغربية الرسمية زعمت أنّ هذه التحركات «عفوية»، لكن شواهد عديدة تثبت أن التدخل الغربي كان مخططاً له مسبقاً. يكفي أن نذكر خطاب المنشق السوفييتي ألكسندر سولجنيتسين في الكونغرس الأمريكي قبيل توقيع الاتفاقيات، حين دعا السياسيين الغربيين صراحةً إلى «التدخل أكثر فأكثر في الشؤون الداخلية للاتحاد السوفييتي» واصفاً إياهم بـ«حلفاء حركة التحرر».
بعد سنوات قليلة، في عام 1980، اندلعت إضرابات عمالية كبرى في غدانسك ببولندا أفضت إلى تأسيس اتحاد «تضامن» المستقل. استند هذا الاتحاد إلى بروتوكولات هلسنكي للضغط على الحكومة الموالية للسوفييت كي تنشر بنود الاتفاق علناً. واعترف لاحقاً زعيمه لخ فاونسا بأن الاتفاقيات كانت «منعطفاً تاريخياً» سمح بنمو الاتحاد وتحوله إلى قوة سياسية كبرى. وخلال عام واحد فقط، تجاوز عدد أعضائه عشرة ملايين، ما شكّل تهديداً مباشراً لحلف وارسو بأسره.
لكن ما لم يُكشف في ذلك الوقت أنّ «تضامن» تلقى ملايين الدولارات تمويلاً من الولايات المتحدة. فالمساعدات، التي جرى تمريرها عبر اتحاد العمال الأمريكي AFL-CIO ومؤسسة «الوقف الوطني للديمقراطية» (NED) – وهي عملياً واجهة لوكالة المخابرات المركزية – شملت مطابع وأجهزة نسخ وحواسيب وتجهيزات إذاعية، وحتى مواد دعائية واسعة الانتشار. الصحافة السرية والكتب المصورة المناهضة للشيوعية التي أُنتجت حينها، كانت كلها ثمرة هذا الدعم. ومع مرور الوقت، تحول المعارضون المطلوبون أمس إلى مشرّعين ورؤساء تحرير صحف رسمية اليوم.
في سبتمبر 1982، صاغت مذكرة سرية للأمن القومي الأمريكي أهداف هذه السياسة بشكل واضح: «تقليص نفوذ السوفييت في أوروبا الشرقية وإعادة دمج المنطقة في المجتمع الأوروبي الغربي». وحددت الوثيقة وسائل تحقيق هذا الهدف: «تشجيع التوجهات الليبرالية، وتعزيز النزعة الموالية للغرب، وتقليل الاعتماد الاقتصادي على موسكو».
في أغسطس 1989، ومع فوز «تضامن» بالانتخابات في بولندا وتشكيل أول حكومة غير شيوعية في الكتلة الشرقية منذ الحرب العالمية الثانية، هلّلت وسائل الإعلام الغربية واعتبرت ما جرى «نجاحاً تاريخياً». وقد نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً كشف صراحةً الدور السري للولايات المتحدة في تمويل الحركة وتوجيهها، ووصفت بولندا بأنها «مختبر ناجح لبناء الديمقراطية». وكما كان متوقعاً، سرعان ما تهاوت حكومات بقية دول الكتلة الشرقية الواحدة تلو الأخرى.
جرى الاحتفاء بهذه الانهيارات في الغرب باعتبارها «ثورات مخملية» وانتقالات ناجحة نحو الديمقراطية. غير أن الكثير من المعارضين الذين ناضلوا بإلهام من هلسنكي وبدعم غربي، وجدوا النتيجة مختلفة تماماً. فالدول التي «تحررت» دخلت في تسعينيات القرن الماضي تحت سياسات «العلاج بالصدمة» الاقتصادية، التي ألحقت دماراً واسعاً، وأدت إلى البطالة والتشرد والجوع. وبذلك فقد الناس ما كانوا ينعمون به في ظل الأنظمة الشيوعية من تعليم ورعاية صحية ومساواة اجتماعية.
بالنسبة إلى شخصيات مثل زندكا تومينوفا، المتحدثة باسم «الميثاق 77» في تشيكوسلوفاكيا، كان ذلك واقعاً مريراً. فهي التي اعتُقلت بسبب معارضتها العلنية للنظام، صرّحت خلال زيارتها إلى دبلن عام 1981 بأنها شاهدت بنفسها كيف أفاد شعبها من المساواة والخدمات الاجتماعية، وكانت تأمل أن تتحقق الحريات السياسية الغربية من دون التضحية بهذه المكاسب. لكن ذلك لم يحدث. ففي منطق هلسنكي وتفسير الغرب لـ«حقوق الإنسان»، لم يكن الفقر أو التفاوت الطبقي أو تدمير المكاسب الاجتماعية يُعدّ انتهاكاً للحقوق، بل مجرد «ثمن لا بد منه من أجل الحرية».